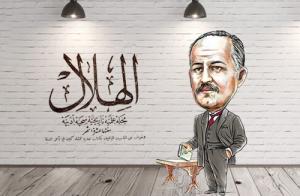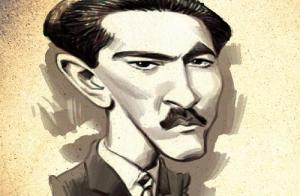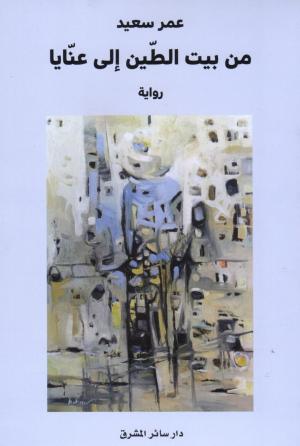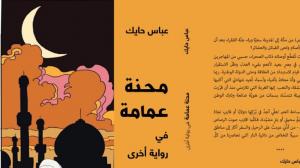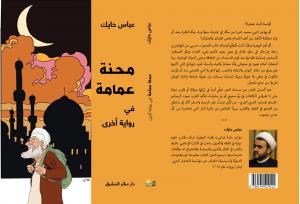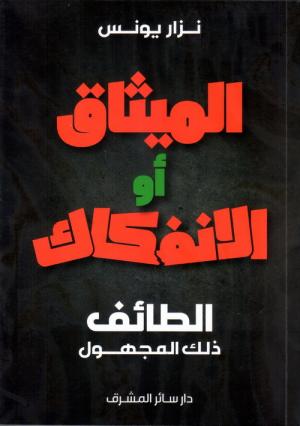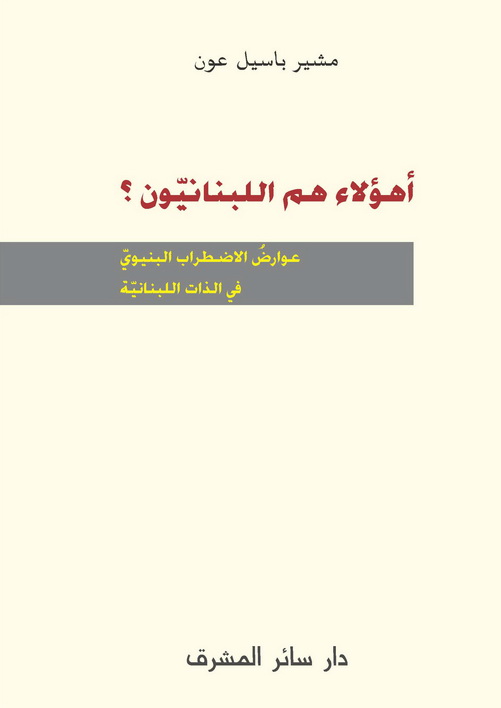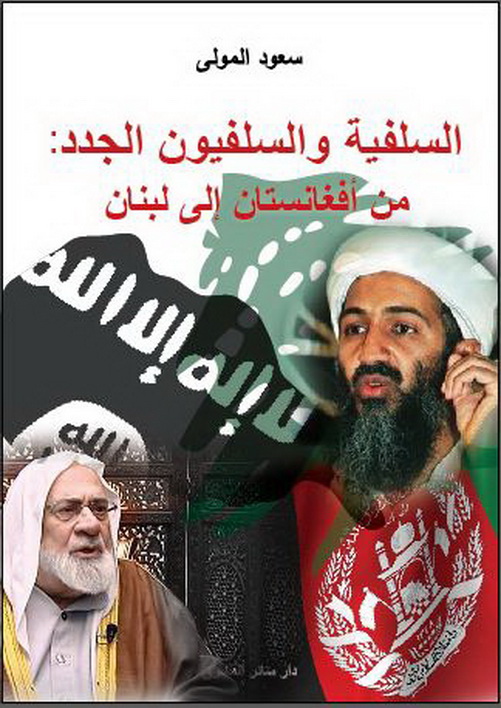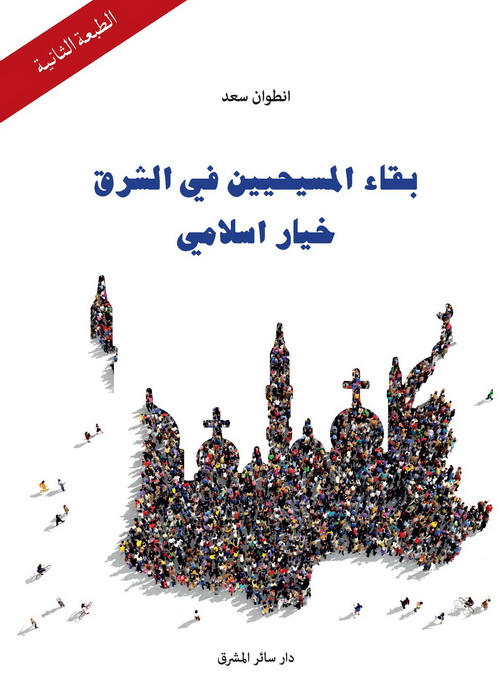مفهوم الحداثة ونقدها عند عبد الوهّاب المسيري
يُعتبر عبد الوهّاب المسيري أحد أبرز المفكّرين العرب في القرن العشرين، وقد تميّز بإنتاجه الفكريّ الخصب، وشَغَلَه هَمّ النهضة العربيّة والإسلاميّة، فحاول تقديم مشروع فكريّ على غرار المفكّرين العرب والمسلمين الذين كان لهم موقف نقديّ من الحضارة الغربيّة وتحيّزاتها، ولاسيّما إشكالية التحيّز للحداثة الغربيّة، محاولاً بهذا النقد البنّاء أن يُعيد صوغ معاني الحداثة تنظيراً و تطبيقاً، بما يتواءم مع الحضارة الإسلامية.






.jpg)